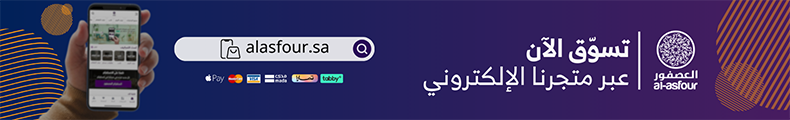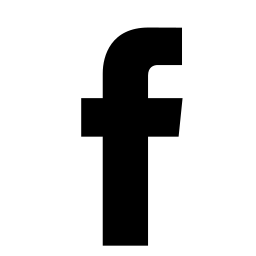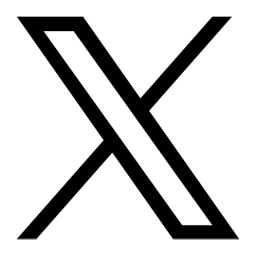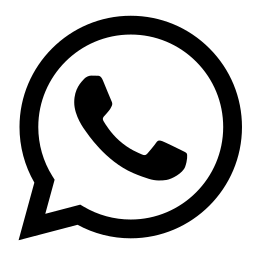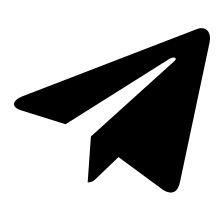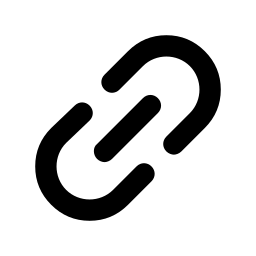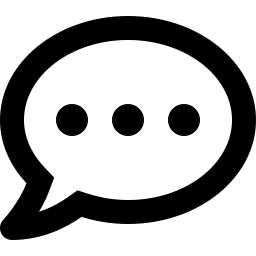المرأة التي لم أكن!
في إحدى ليالي شهر رمضان المنصرم وتكفيرا عن التهامي طبقا كاملا من اللقيمات الشهية المغمسة بدبس التمر، خرجت لحرق بعض السعرات الحرارية في ممشى حديقة الحي العتيقة. وبينما كنت أتقدم في الممشى تناهى إلى مسامعي صوت نحيب رجل، لا حظت تلفت الشباب الذين يسبقونني نحوه، أبطأوا سيرهم قليلا ثم أكملوا دون أن يقتربوا منه. تقدمت بدوري حتى أصبحت بمحاذاته، شاب ثلاثيني يبكي بكل جوارحه لم يتكلف حتى عناء إخفاء وجهه بكفيه بل أطلق تنهيداته الحارة ودموعه. تسرُب أنينه إلى روحي سمر قدمي في الأرض، لوهلة تخيلت أني في إحدى حلقات برنامج الصدمة الذي كان يعرض حينها. توقفت وأنا في حيرة لا أدري ما الذي علي أن أفعله الآن، تعاطفي الشديد لم يكن كافيا كي أقدم على أي خطوة، آلاف التساؤلات التي تمنعني، هل يليق بامرأة غريبة أن تهب لمواساة رجل! هل يحتاج أصلا للمواساة أم أن كل ما يحتاجه هو أن يترك وحيدا مع دموعه؟! ماذا لو اقتربت ألن يفزعه اقترابي؟! هل نسيت أننا في مجتمع الخطوط الحمراء؟! أليس مجرد روح تغرق في لحظة ضعف أم أنه رغم ذلك يبقى ذئبا على نعجة ضعيفة مثلي أن تحذره؟! المهم أن تلك التساؤلات أخرستني ومنعتني من الاقتراب، دعوت الله أن يلطف به ومضيت.
بعد عدة أشهر كنت أمر بإحدى الليالي، كانت رؤيتي معتمة حينها حتى خيل إلي أن الأبواب جميعا موصدة، وأن الطريق مسدود. كنت على يقين أن وجهي المتورم وصوتي المتحشرج سيفضحانني لا محالة. لم أشأ أن يرى صغاري أمهم في لحظة ضعف، لم أرد أن يعرفوا أنها أحيانا تخسر في مواجهة الحياة، شعرت أن منزلي المكتنز بالأطفال يخنقني، حينها تذكرت الحديقة العتيقة، ستساعدني حتما على التنفس، سأسند ظهري لأشجارها الضخمة التي تفوقني عمرا، سأتأمل أغصانها المتراقصة مع النسمات وأتذكر صمودها رغم تبدل المواسم، فهي لا تزال شامخة رغم أنها تعرت واكتست عشرات المرات. وصلت وبحثت عن مقعد المبكى ذاته.
جلست وسمحت لطوفان الدموع الذي كنت أقاومه أن يتدفق، لحظات ولحقت به العبرات التي كانت متكدسة ومخنوقة في صدري. غرقت في ملكوت الأحزان والخيبة بكل جوارحي، كم كنت مستسلمة لذاك الغرق. حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، يد غريبة تماما تمتد وتربت على كتفي بحنان. تطل بوجهها المكتنز وابتسامة متعاطفة عجيبة تملؤه، تمسح دموعي دون استئذان وتهمس «بتعيطي ليه!»... حاولت أن أوصد مشاعري دونها، أن أصدها برفق، أن أتم شعيرتي المجنونة وحدي دون فائدة، فقد غمرتني بالعاطفة والحب، تعجبت كيف لغريبة لم تلتق بي قبل الساعة أن تمنحه! تجاذبنا أطراف الحديث وأخبرتها عن القشة التي قصمت ظهري ودفعت بي إلى البكاء. «بس كدة! دنتي بتدلعي يا بت»...
المهم أنها باحتوائها لي وظرافتها ولهجتها المصرية المحببة إلى قلبي استطاعت أن تنتشلني من الحفرة التي هويت بها بملء إرادتي ولم أطلب المساعدة حتى من أعزائي. فكانت بذلك رسولا لتذكرني أن الدنيا لا تزال بخير ما دامت عامرة بالطيبين أمثالها. عدت إلى منزلي بوجه مبتسم وروح خفيفة، وقد استصغرت مشاكلي وأصبحت أنظر لها من زاوية جديدة وكأنها عثرة طريق باستطاعتي أن أركلها وأمضي. حينها بدا لي بكل وضوح أن الدنيا صعبة موحشة وثقيلة فقط حين نواجهها فرادى، وأننا معا لا نهزم وأن الناس للناس، كل ما علينا أن نمد أذرعنا قدر اتساعهما حتى نصل ونتصل.
كن هناك من أجلهم، يكونوا هنا من أجلك!