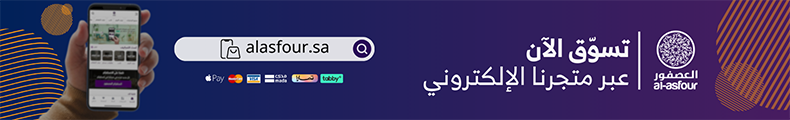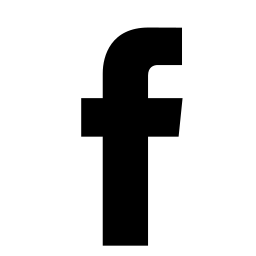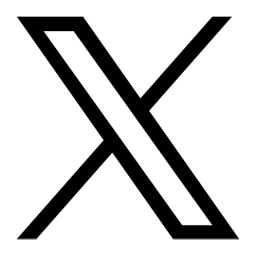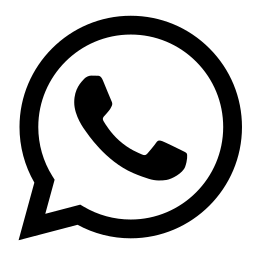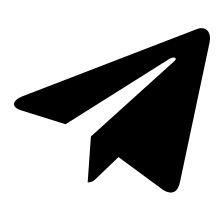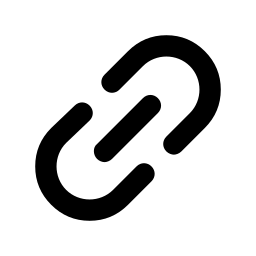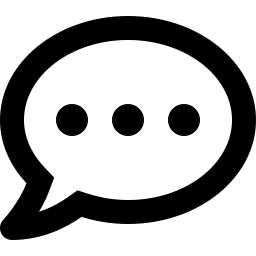يوميات العزل الصحي «10»
للتو عدت من ربيع البساتين في غرب المدينة، الأوامر التي أغلقت المساحات العامة، جعلت من المشي في فضاء الرقعة الخضراء خياراً بديلاً، رجلاي تعرفان هذا الطريق جيدا، فهي تمشي بكثير من الخفة هناك حيث الدهشة الأولى التي أيقظتني إلى المعنى الآخر للمكان، دروب صافحت فيها ذاكرة الأجداد، وتعرفت من خلالها على نبوءات الماء التي أنبضت الحياة في هذه الأرياف.. الوجوه التي غرفتُ من معين ذكرياتها قبل أن تلوح بالرحيل، كانت تطل بصورها في المخيلة كلما عبرت من مجالسهم التي انتهت للتجريف بعد رحيلهم.
لكل واحد منا رئتان يتنفس بهما، وأنا أشعر بأن البحر والبساتين هما رئتاي ساعة أبحث عن نفس عميق، نسمة هواء مبتلة برطوبة المكان، الخوف الذي يجتاح المدينة طوق البحر بحواجز العزلة، فلا يصلنا منه إلا بزوغ الشمس ساعة تغسل أحزانها في أول الشروق، هنا أستعيد جسر البساتين بحثاً عن حرية وأمنية بنسائم تطرد عن صدورنا بقايا الأخبار التي تنشقناها ليلة البارحة.. تباغتنا الغيوم هذا الصباح لتهب المنظر الزراعي بهجة الربيع، لا مطر في الأفق، ولا في نشرات الأرصاد، غير أن طقساً كهذا سيكفي ليمطرنا بأسباب الفرح.
الفلاحون يسابقون الطيور في الوصول إلى مزارعهم، يستعينون بدفء الشمس في الساعات الباكرة للقيام بأعمالهم، يلوحون لك بابتسامة معجونة بتعب الغربة، سحنتهم تكشف عن هوياتهم، هم قادمون في الأغلب من الهند والبنغال، يزرعون ويقطفون، يحرثون ويمهدون، ليقبضوا نهاية الشهر مبلغاً يعينهم على رعاية أحلامهم في الوطن الأم.. لا ترى في عيونهم بريق أحلامهم، ولا الحكايات التي جمعوها في سنوات ضاع فيها عنوان الوطن. تخجل أن تراهم بهذا النحو المتكرر ولا تتكرث لأسمائهم، كأنه نفي آخر لوجودهم، ودفع بهم مستمر إلى دائرة المجاهيل.
كأن هذه الغربة تمشي بهم إلى دوائر النسيان، أتذكر إعلانات وزارة الصحة وهي تستثنيهم في إعلاناتها التوعوية لمواجهة المرض، البلاغة فيها قاصرة، وقصورها أنها لا تصل إلى كل الناس، فيما قلق الغريب لا يضاهيه قلق، منذ الساعات الأولى للإعلان عن إصابات الكورونا في شرق الوطن، كانوا هم أول المعبرين عن خوفهم منه، يتوسلون الكمامات لطرد الهواجس الثقيلة عن قلوبهم، كان المرض في أوله، وهم كمن في ذروة الاستعداد له، ولو في صورة بسيطة جرى اختزالها في كمام، يراد منه أن يحرسهم ويحرس ما تبقى من أحلام هجرتهم.
متعبة هي الغربة في حدها العاطفي، في المسافة التي تفصلنا عن من نحب، وعن الأرض التي نكابد من أجل أن نعود إليها، وفي قبال شبح الطرد وخسارة الوظيفة في هذه الأزمة، يقف شبح الخوف من أن يعود الغريب وقد لف مع أحلامه في كفن، تصبح الحياة بكاملها لحظة لا تحتمل كالموت، كلما فكر في إمكانية أن يأخذه القدر إلى مصير مؤلم كهذا، تتواضع الأمنيات ويصبح غاية المنى أن يخرج سالما معافاً من هذه الأزمة، أو أن يعود ليعانق أطفاله وأهله قبل الرحيل.
هذا الشعور هو ما يفسر الإحساس المضاعف بخطورة المرض عندهم، وهو الفارق في التعبير عن قلق الأزمة بين الوافد والمواطن، فخبر واحد كان كفيلاً بأن يحملهم للتفكير في تحصين أنفسهم، بينما احتجنا إلى حزمة إعلانات وقرارات وإجراءات لندفع المواطنين دفعاً باتجاه الإحساس بخطورة الموقف، وخطورة التساهل في التعاطي مع تطورات المرض، فكأن القلق مهارة تعلمنا إياها الحياة، وأن الاغتراب يغذيها وينميها، ويجعلها مزرعة لمضاعفة الخوف.