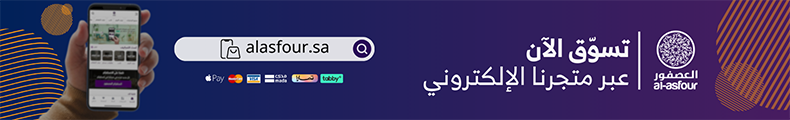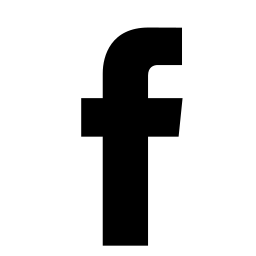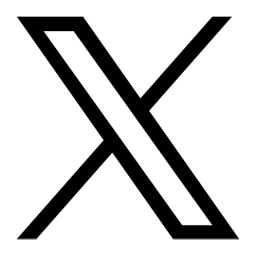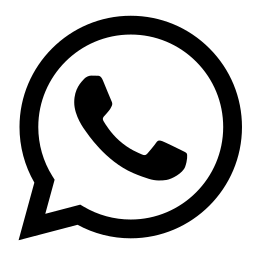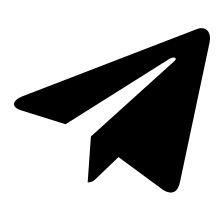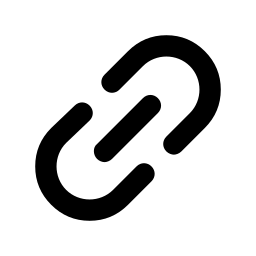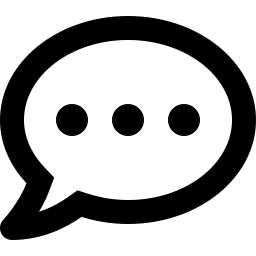هل وجودنا في الحياة نعمة أم نقمة ؟!
في زمن المنتديات وعبر «شبكة الجفر الثقافية» أرسل إليّ أحد الإخوة الأعزاء رمز لنفسه باسم «إسبانتا» السؤال التالي: تحية لأستاذي الكبير ابن عساكر.
نسمع ونقرأ أن من حقوق والدك عليك أنه كان سببا لوجودك في هذه الدنيا، وأن من نعم الله تعالى التي لا تحصى هي نعمة الإيجاد.
فهل الإيجاد في هذه الدنيا - رغم ما بها من منغصات وآلام وعذاب وخوف - هو نعمة؟! فيكون والدي له الفضل في ذلك، أم هناك تفسير آخر لعله يرفع هذه الشبهة لدي؟!
فقلت في جوابه نصا: أهلاً بك أخي الكريم الأستاذ إسبانتا.
صحيح ما ذكرت، ولا أراني سأضيف جديداً إلى ما به تفضلت، فإن الآباء هم الأصل في تكوين الأبناء، والعلة المباشرة في خلقهم وإيجادهم في الحياة، ذلك أن الأبناء إنما هم من مياه آبائهم يتكونون، ومن أصلابهم إلى أرحام أمهاتهم ينحدرون، إذ عن طريق لقاء الأبوين يتم تلقيح البويضة، وانعقاد النطفة في رحم الأم.
وأما عن كيفية التلقيح فما يقوله العلم هو أنه: «في كل اتصال جنسي تنصب ملايين الخلايا الذكور أو الحيوانات المنوية في المهبل، ويندفع بعضها عن طريق الرحم إلى البوق.
وخلايا الذكور هذه سريعة الحركة إلى حد يمكنها أن تصل خلال ساعة بعد الجماع إلى البوق، فإن وجدت إحداها بويضة حية هناك أصبح التلقيح أمراً محتمل الوقوع.
أما إذا لم تجد بويضة حية فإنها تموت خلال بضعة أيام، أما تلك التي داخل المهبل أو قريبة، فإنها تموت في مدى «24» ساعة.
وعندما تصل خلية ذكر إلى أخرى أنثى، فإنها تثقب الطبقة الخارجية الواقية ويسقط ذيلها في طبقة المواد الغذائية وتتحد مع نواة الخلية الأنثى.
وهذا هو التلقيح، وبه تبدأ حياة جديدة».
وإليه الإشارة في النصوص الإسلامية كتاباً وسنة كقوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ﴾.
وفي الآية الكريمة إشارة واضحة إلى بداية خلق الإنسان، وأن تكوينه بدأ ﴿مِن مَّاء دَافِقٍ﴾ وهو المادة المنوية التي يصبها الرجال في أرحام النساء، وأن هذه المادة المنوية إنما تخرج ﴿مِن بَيْنِ الصُّلْبِ﴾ وهو الظهر، ﴿وَالتَّرائِبِ﴾ جمع تريبة، وهي عظم الصدر.
ولهذا أكد الإمام علي بن الحسين زين العابدين  على أن الأب هو الأصل في وجود الأبناء، ولذلك فهو أصل كل ما فيه الابن من النعم، فقال صلوات الله وسلامه عليه في بيان عظم حقه، كونه الأصل في نعمة وجود الأبناء، وما يتفرع عيها، وينبثق منها من النعم: «وحق أبيك أن تعلم أنه أصلك، وأنه لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله».
على أن الأب هو الأصل في وجود الأبناء، ولذلك فهو أصل كل ما فيه الابن من النعم، فقال صلوات الله وسلامه عليه في بيان عظم حقه، كونه الأصل في نعمة وجود الأبناء، وما يتفرع عيها، وينبثق منها من النعم: «وحق أبيك أن تعلم أنه أصلك، وأنه لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله».
ومن الواضح أن كون الأب هو الأصل في وجود الأبناء ليس بمعنى أنه الخالق لهم، ولا أنه علة مستقلة في الفعل والتأثير، وإنما بمعنى أنه علة تقع ضمن علل متسلسلة إلى أن تنتهي إلى علة العلل التي ليس فوقها علة، والمتمثلة في الذات الإلهية المقدسة، التي هي العلة الحقيقية في خلق وصنع كل الأشياء، وإفاضة الوجود على جميع الموجودات.
وبتعبير أوضح: إن الخالق للإنسان هو الله عز وجل، وما الأب والأم إلا سبب عن طريقهما تم هذا الخلق والإيجاد، ذلك أن الله تبارك وتعالى «أبى أن تجري الأمور إلا بأسبابها، فجعل لكل شيء سببا...» كما يقول الإمام أبوعبد الله الصادق  .
.
الوجود أعظم النعم:
وأما عن وجودنا وهل هو نعمة أم نقمة؟ فلا يشك عاقل أن الوجود أفضل من العدم، وعليه يكون وجودنا - بغض النظر عن كل الاعتبارات - أفضل من عدمه، وبما أنه أفضل، فهذا يعني أنه نعمة في حدّ ذاته.
وبتعبير أكثر وضوحاً نقول: بما أن وجود الشيء أفضل من عدمه، فإن مجرد وجودنا في الحياة هو أفضل من عدم وجودنا، كما أن هذا الوجود يمثّل نعمة إلهية كبيرة لا تقدر بثمن، بل لا شك في أن نعمة إيجاد الإنسان في الحياة هي أعظم النعم وأفضلها، ذلك أن كل النعم الأخرى متعلقة بها، متفرعة عليها، ولولا أن الله تعالى أوجدنا وإلا لأصبح الخلق عبثا، ولم يكن هناك ما يدعو إلى إيجاد هذا الكون بكل ما فيه من خيرات حسان، ونعم هي فوق العد والإحصاء.
وهذا ربما مما يدرك بالبداهة العقلية، كما أنه ما تؤكده النصوص الإسلامية، خصوصاً القرآن الكريم، الذي فيه عشرات الآيات التي تتحدث عن هذا الكون، وتؤكد أن الله عز وجل لم يخلقه إلا لنا، ومن أجلنا.
ولك أن تستجلي هذه الحقيقة الجلية من خلال التدبر في هذه الآيات المباركة: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ * هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ * وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ * أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.
ولاحظوا أن كلمة «لكم» تكررت بعد ذكر كل «خلق» وعدّ كل «نعمة» تذكرها هذه الآيات المباركة، لتؤكد أن ذلك كله إنما كان لنا ومن أجلنا.
ثم أجمل الله هذا التفصيل فقال تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ليبين سبحانه أن نعمه علينا لا تنحصر فيما ذكره وعدده، بل هي بلغت حداً من الكثرة الكثيرة، بحيث أننا لا نستطيع أن نعدها أو نحصيها!
ولهذا ورد في الحديث القدسي: «عبدي: خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، وهبتك الدنيا بالإحسان والآخرة بالإيمان».
وهو حديث يفيد أن كل الأشياء إنما خلقها الله من أجل الإنسان، وسخرها له، وجعلها في خدمته، ومن أجل راحته وسعادته، وجعله سيد هذا الكون بكل ما فيه، وأعطاه التكريم، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، تماما كما يقول عز وجل: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾.
وهنا يجب أن نلاحظ أن هذا الحديث القدسي الشريف في الوقت الذي يؤكد فيه أن الله عز وجل إنما خلق الأشياء - كل الأشياء - لأجل الإنسان، أيضا يؤكد أنه تبارك وتعالى وهبه الدنيا - كل الدنيا - بالإحسان، ولا شك أن الإحسان من التفضل والمنن والنعم.
ولهذا قلنا والآن نؤكد: إن نعمة خلق الإنسان وإيجاده في الحياة هي أعظم وأفضل النعم، وكل النعم الأخرى متعلقة بها، متفرعة عليها، بل لولا نعمة إيجاد الإنسان وإلا لما أصبح لوجود الكون معنى، ولأصبح الخلق عبثاً، والله منزه عن العبث واللعب ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ﴾.
وإنما قلنا: إنه لولا وجود الإنسان وإلا لأصبح الخلق عبثاً، لأن الإنسان نفسه لم يخلق عبثاً: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾.
إذن الله لم يوجدنا في الحياة عبثاً ولا لعباً، وإنما لغرض عظيم، يكشف عنه القرآن الكريم في قوله الحكيم: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾.
فغرض الخلقة أن نكون عابدين له سبحانه، ولو أنه عز وجل أوجد الكون ولم يوجدنا فيه، لما تحقق غرضه عز وجل من الخلق والإيجاد، وإذا لم يتحقق الغرض بانتفاء وجود من يحققه ويجسده، أصبح الخلق عبثاً، ولعل هذا من معاني حديث: «خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي...»
فالغرض من خلق الأشياء أن تكون في خدمة الإنسان، والغرض من خلق الإنسان أن يكون عابداً لله، مما يعني أن تجسيد العبودية الحقه لله تعالى هو الغرض الأساس من خلق الكون والإنسان معاً.
وبهذا البيان يتضح لنا أن نعمة إيجاد الإنسان هي أفضل النعم، وأنجمع النعم الأخرى متعلقة بها، متفرعة عليها، منبثقة عنها، وأنه لولا أن الله أوجدنا وإلا لأصبح إيجاد الكون عبثاً، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
مع التعارض بين نعمة الإيجاد وبين ما في الدنيا من مصائب:
نأتي الآن إلى لبّ الموضوع الذي يريد منا الأخ الكريم «إسبانتا» بيانه، وهو: هل هناك تعارض بين نعمة الإيجاد وبين ما في الدنيا من مصائب وآلام تنغص حياة الإنسان، وتعكر صفو معيشته؟!
وهذا السؤال يدور في خلد الكثيرين من الناس، وطالما سمعناه يترد على ألسنتهم، بل ربما تطرف البعض فقال: إن ما في الدنيا من مصائب ومحن ومتاعب ينقض القول: بنعمة الإيجاد، ويثبت أن الإنسان إنما خلق ليشقى ويتألم! فكأن الإيجاد عند هؤلاء نقمة وليس نعمة!
وهذا ما جعلنا نفيض الحديث عن نعمة الإيجاد، ونتوسع في شرحها، ونحاول أن نثبت أنها ليست مجرد نعمة، بل هي أفضل النعم الإلهية وأعظمها على الإنسان.
أما الذين يتصورون أن الإنسان خلق من أجل الشقاء، ويتخذون مما في الدنيا من مصائب وابتلاءات ومحن دليلا على ذلك، فلا شك أنهم في قولهم هذا واهمون، وفي رأيهم مشتبهون، والحق أن الإنسان لم يخلق ليشقى ويتألم، بل ليسعد ويتنعم، وما يوجد في هذه الدنيا من مصائب وآلام لا ينقض القول بنعمة الإيجاد، ولا يحولها إلى نقمة، ولا يعني أن الإنسان خلق من أجل البؤس والشقاء والتعاسة.
الإنسان خلق من أجل السعادة:
نحن لا نشك في أن وجود الإنسان نعمة وليس نقمة، بل هو أعظم النعم كما بينا، وأنه لم يخلق من أجل الشقاء والتعاسة، وإنما خلق من أجل السعادة والهناء في الحياة الدنيا، والراحة والنعيم في الحياة الآخرة.
ويمكننا أن نقدم مجموعة كثيرة جدا من الأدلة على ذلك، نجملها في النقاط التالية:
النقطة الأولى - الدنيا ليست كلها مصائب:
إن الدنيا ليست كلها آلام ومصائب كما يتوهم البعض، بل فيها من وسائل الراحة ومختلف اللذائذ المادية والمعنوية ما لا عدّ له ولا حصر، فهل يصح أن نتغافل عن كل هذه النعم، ونقول إن الحياة كلها ألم وتعب؟!
النقطة الثانية - النعم هي الأصل والنقم طارئة وزائلة:
إن الراحة والسعادة والاستمتاع بالنعم هو الأصل، وأما المصائب والمحن والمنغصات ما هي إلا أمور عارضة وطارئة، بل وزائلة أيضا.
فمثلاً: الصحة نعمة، وهي الأصل، والمرض طارئ وعارض، وقابل للزوال، بمعنى أن الإنسان قد يشفى من مرضه بعد أيام وتعود إليه صحته وعافيته.
وهكذا الحال في سائر الأمور الأخرى، فنعمة الأمن هي الأصل، والخوف عارض وقابل للزوال، ونعمة الراحة النفسية والجسدية هي الأصل، والتعب النفسي والبدني عارض، وقابل للزوال، ونعمة المودة والرحمة بين الزوجين وفي النظام الأسري هي الأصل، وما يتخلل الحياة الأسرية من مشاكل وخلافات كلها عارضة وطارئة وقابلة للزوال... وهكذا سائر النعم التي يرفل ويتمتع بها الإنسان، كلها هي الأصل، وما يطرأ عليها من منغصات وآلام كلها أمور طارئة وزائلة.
وهذا يعني أن الإنسان يعيش أكثر حياته في النعم وليس في الألم، فمثلاً الإنسان يعيش أكثر سنوات عمره في الصحة والعافية وليس في العلل والأمراض، وأكثر عمره يمضيه في الأمن والطمأنينة والاستقرار، وليس في الخوف والقلق والاضطراب... وهكذا سائر الأمثلة الأخرى.
وليس هذا فقط، بل - كما أشرنا والآن نؤكد - فإن النقم والمنغصات كما أنها عارضة أيضا زائلة، بمعنى أنه بعد المرض تعود الصحة، وبعد الخوف يعود الاطمئنان، وبعد الخلاف والشقاق يعود الصلح والوئام... وكل هذا مما يؤكد أن السعادة هي الأصل، والشقاء طارئ وزائل.
وإذا كان الأمر كما بيناه مما لا سبيل إلى إنكاره، فكيف يزعم الزاعمون أن الحياة كلها مصائب، وأن المصائب تنقض القول بنعمة الإيجاد؟!
أما الذين قد يشكلون على هذا البيان بأن البعض قد يموتون في مرضهم، أو لا يصلحون بعد خلافهم... فنقول لهم: هذا الإشكال في غير محله، لأن حديثنا عن القاعدة العامة، التي هي الأصل، وليس عن شواذها، الذي هو الطارئ، وكلنا نعلم أن لكل قاعدة شواذ، ولا يصح أن نترك القاعدة العامة ونتجاهلها، ونتمسك بشواذها.
النقطة الثالثة - بعض المصائب من فعل الإنسان نفسه:
إن الكثير من المصائب والآلام التي يعانيها الإنسان إنما هي من فعله وباختياره، فالقتل، والظلم، وغصب الحقوق، وانتهاك الحرمات، وهتك الأعراض، والتعدي على الآخرين، ونهب الثروات، وأكل مال اليتيم... كلها مصائب عظيمة، وتسبب للإنسان آلاماً كبيرة، ولكن كلها من فعله هو، وفعلها بكامل حريته وإرادته واختياره، ولو أنه لم يفعل شيئاً من هذه الجرائم لما عانى شيئاً من تلك الآلام.
وسبق أن قلت في بعض مؤلفاتي: «... لو التزم كل الناس بالحق، وساروا على هديه، وجعلوه دستورهم في الحياة، لانتفت كل المصائب الكبيرة، والجرائم العظيمة، وانتهت كل المشاكل المستعصية والمعقدة، ولما تخاصم الناس، ولما عاشوا في شجار ونزاع، ولما احتاجوا إلى القضاء، ولأغلقت المحاكم أبوابها، ولخلت السجون من المجرمين، بل ولما شرّع الله الحدود وجعل القصاص، ولرأيت الناس يعيشون على هذه الأرض عيشة ملائكية، تسودهم المودة والرحمة والمحبة والتكاتف والتآخي والتآزر... وهم يرفلون بالنعم والرخاء، ويتمتعون بالسعادة والهناء».
فإذا أراد الإنسان أن يستشعر نعمة الإيجاد، بل ويعيشها، ويستمتع بملذات الحياة، ويتخلص من الكثير من المصائب والآلام التي جلبها لنفسه، فليترك الجريمة، وليتحلى بالأخلاق الكريمة، والآداب الرفيعة، وحينها سيشعر بالراحة، وسيرفل بالسعادة، وسيرى الدنيا وكأنها جنة الله العريضة التي أعدها سبحانه لعباده المتقين.
أما أن يمارس الجريمة، ويحول الدنيا إلى غابة، ويملأها - برا وبحرا، وسهلا وجبلا، وجوا وأرضا، وفي الحضر والبدو - بالظلم والفساد، ويجلب لنفسه والآخرين البؤس والشقاء، ويغير نعمة الله كفرا، فهذا ذنبيه، وعليه أن يتحمل نتائجه.
النقطة الرابعة - عمل الإنسان سنة مؤثرة في الكون:
وهي شبيهة بالنقطة الثالثة مع وجود فرق دقيق لمن تأمل، وملخص هذه النقطة هو أن الكثير مما تعانيه البشرية من مصائب إنما هو نتيجة طبيعية لعدم تجسيدها لغرض الخلقة المتمثل في عبادة الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الله عز وجل جعل هذا الكون خاضعاً لمجموعة من السنن المؤثرة فيه سلباً وإيجاباً، والمجتمع الإنساني محكوم بهذه السنن، خاضع لها في راحته وتعبه كما في سعادته وشقائه.
ومن هذه السنن ما هو «مادي» كتعاقب الليل والنهار أثر حركة الأرض، ومنها ما هو «معنوي» كتأثير عمل الإنسان في الحياة سلباً أو إيجاباً.
فالأمة التي تعيش الإيمان والتقى والارتباط بالله تعالى، يفتح الله عليها البركات، ويجعلها تعيش الأمن والرخاء، والأمة التي تكفر به، وتعرض عنه سبحانه وتعالى، تبتلى بالمصائب المختلفة، التي تنغص عليها عيش الحياة.
وهذا ما يؤكده القرآن الكريم والسنة الشريفة والأحداث التاريخية، وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.
وقد شرحنا هذا المعنى تفصيلاً في ص24-28 من كتابنا «العدل الإلهي» أثناء حديثنا عن «فلسفة الشر» تحت عنوان: «عمل الإنسان سنة مؤثرة في الكون» والكتاب مطبوع ومنشور فراجعه لتقف على التفاصيل ويتضح لك المعنى بالكامل.
ولكني أقول الآن: إذا كانت هذه الآلام إنما هي نتيجة الإعراض عن الله، وعدم الإيمان به سبحانه، فهذا يعني أننا نستطيع أن نتخلص منها بالعودة إلى إليه عز وجل، لننعم بالراحة، ونشعر بمدى عظمة نعمة الخلق والإيجاد.
النقطة الخامسة - خير الحوادث أكثر من شرها:
إن الفوائد المترتبة على الحوادث الطبيعية، كالزلازل والبراكين والأعاصير والرياح العاتية... أكثر مما تسببه هذه الحوادث من أضرار، وتخلفه من دمار.
وهذا ما تؤكده البحوث العلمية الحديثة التي تتناول مثل هذه المواضيع، فاقرأ من هذه الكتب والبحوث ما تشاء لترى أنها تؤكد صدق ما نقول، وذلك أثناء حديثها عن الآثار الإيجابية الناتجة عن هذه الحوادث الطبيعية المؤسفة المؤلمة.
وإذا كان ما تسببه هذه الحوادث رغم عظمته وآثاره السلبية، إلا أنه يعد بسيط وقليل قياسا بما يترتب عليها من فوائد جمة، وخيرات كثيرة، فلا شك أنها لا تعتبر مصائب وآلام بقدر ما تعد من ضمن النعم ذات الفوائد العظيمة!
وإلى هذه الحقيقة الجلية يشير فيلسوف العصر الإغريقي الكبير «سقراط» حين أكد أن الموجودات الممكنة - بالقسمة العقلية - تنقسم إلى خمسة أقسام:
1. ما هو خير محض لا شر فيه أبداً.
2. ما فيه خير كثير مع شر قليل.
3. ما فيه شر كثير مع خير قليل.
4. ما يتساوى فيه الخير والشر.
5. ما هو شر محض، لا خير فيه أبداً.
ولا يوجد شيء من الأقسام الثلاثة الأخيرة في العالم، لأن ذلك يستلزم الترجيح من غير مرجح، بل ترجيح المرجوح على الراجح، فلا يوجد في الدنيا إلا ما هو خير محض، وما خيره أكثر من شره.
وعلى هذا فإن نسبة وجود الشر والألم قليلة جداً، بل هي نادرة وتكاد تكون معدومة إذا قيست بوجود الخير الكثير، كما أن الشر القليل إنما وجد بتبع الخير الكثير.
إذن الدنيا كلها خير، وكل ما فيها هو نعيم، ولا يصح أن نقلب الآية ونقول: الدنيا كلها آلام ومتاعب، وإن هذا ينقض القول بنعمة الإيجاد!
النقطة السادسة - النقم نعم!:
إن النقم والآلام والمصائب هي في حد ذاتها نعمة، كما هو واضح من خلال النقطة الخامسة، ونزيده إيضاحا من خلال هاتين الفقرتين:
1» إن الأشياء لا تعرف إلا بأضدادها - كما في المنطق - ففي النظام الكوني: لولا الليل لم نعرف النهار، ولولا الظلام لم نعرف النور، ولولا الحر لم نعرف البرد...
وكذلك الحال في «النعم والنقم» فلولا الخوف لم نعرف الأمن، ولولا المرض لم نعرف الصحة، ولولا التعب لم نعرف الراحة، ولولا الشقاء لم نعرف السعادة...
وهذا يعني أننا إنما تعرفنا على النعم، وعلى قدرها وقيمتها وأهميتها في حياتنا من خلال النقم، ولولا ذلك وإلا لما شعرنا بأي نعمة، وذلك لأنه مع الغفلة وعدم الشعور بالنعمة لا يمكن أن نلتفت إليها، ومع عدم الالتفات إليها لا يمكن أن ندركها، وإذا لم ندركها لم نعرفها، وإذا لم نعرفها لم نقدر قيمتها، ومع عدم تقدير قيمتها لا يمكن أن نشكر الله عليها، وعدم شكره تعالى على ما أنعم يعني الكفر بنعمه، والكفر بالنعم يعرضها إلى الزوال، ويعرضنا إلى غضب الله ولعناته الأبدية.
أرأيت كيف أصبحت هذه المصائب هي سبب اتصالنا بالله، وشكرنا له وفق التسلسل الذي ذكرناه؟! وهل يبقى بعد ذلك مجال للقول بأن الألم ينقض الاعتقاد بنعمة الإيجاد؟!
2» إن هذه المصائب تعتبر من أهم العوامل المساعدة على الحد من طغيان الإنسان وتجبره، لأنها تكشف له ضعفه وعجزه، واحتياجه الدائم إلى ربه.
كما أنها من أهم العوامل التربوية للإنسان، ولها الدور الفاعل في بناء شخصيته، وشد عزيمته، لتخلق منه إنساناً عظيما، قادراً على مواجهة الشدائد بروح عالية لا تعرف الهزيمة أبداً.
فالإنسان الذي يعيش دائما حياة مرفهة، وكلها دعة وراحة، ينشأ على الكسل والخمول، ويكون ضعيفا مهزوزا، ولا يعرف كيف يتعامل مع أحداث الحياة المتقلبة، عكس الإنسان الذي تتخلل حياته بعض المصائب، وتعترضها بعض المشاكل والعقبات، فإن ذلك يكسبه المران العملي على المواجهة والتحدي، ويعطيه القدرة على العمل على الخلاص من المعوقات، وتخطي العقبات بالهمة والعزيمة، وقوة الإرادة، وصلابة الموقف.
انظروا إلى أطفال الحجارة كيف صنعت منهم الظروف المعقدة، والمصائب المختلفة أبطالا ًأشداء أقوياء، لا يهابون الموت، ولا يخشون الطغاة، ويواجهون الدبابة بحجارتهم بكل بطولة وشجاعة، ويستقبلون الموت بثغر باسم، ونفس مطمئنة.
وهل صنعتهم إلا المصائب، أم هل بنتهم إلا النوائب، رغم ما بها من مرارة وألم؟!
النقطة السابعة - الدنيا طريق الآخرة:
إن الإنسان لم يخلق ليخلد في هذه الدنيا، وإنما لينعم بالعيش الأبدي في ﴿جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾.
والوصول إلى تلك الجنة متوقف على الإيجاد في هذه الحياة، وهذا يعني أن إيجادنا في هذه الدنيا هو أعظم نعمة، لأنه سلّم الوصول إلى تلك الحياة السعيدة، التي بإمكان كل أحد أن يصل إليها، ويحظى بها، إذ آمن بالله، وكان من المتقين.
أما ما يمكن أن يواجهه الإنسان في هذه الحياة من مصائب ومتاعب، فإضافة إلى كل ما ذكرناه في النقاط السابقة، أيضا هو ابتلاء إلهي، إذا صبر الإنسان عليه، ونجح فيه، نال المقامات العالية، والدرجات الرفيعة في الدنيا والآخرة، كما تؤكد وتثبت ذلك النصوص الإسلامية الكثيرة كتابا وسنة.
الخاتمة:
هناك نقاط أخرى كثيرة تؤكد أن وجودنا في هذه الدنيا هو أعظم النعم، وأن ما في الحياة من آلام لا ينقض هذه الحقيقة، بل يعززها ويثبتها، كما أن بعض ما نعده نقمة ما هو - في واقع الحال - إلا نعمة لمن تأمل وتدبر.
ولو أردت الاسترسال في تسجيل هذه النقاط، لذكرت الكثير منها، ولكني أرى نفسي أطلت كثيراً ولا أريد الإطالة أكثر، وفقط أشير إلى ثلاثة بحوث سبق أن كتبتها، وأرشدك «أخ إسبانتا» وسائر الإخوة والأخوات إليها، فلعلها تفيدكم في التوسع في الموضوع.
البحث الأول بعنوان «الابتلاء وأنواعه» وهو موجود في زاوية «سين جيم» من قسمي الخاص على هذه الشبكة، في إجابة سؤال «وعجل فرجهم»
البحث الثاني بعنوان «لماذا يبتلي الله المؤمنين وينعم الكافرين؟!» وهو أيضا موجود في قسمي الخاص من هذه الشبكة.
البحث الثالث بعنوان «ما هي فلسفة وجود الشر؟!» وهو في كتابي «العدل الإلهي وفلسفة الشر والابتلاء والخلود في النار» وهو مطبوع ومنشور، فارجع إليه إن كان عندك، فإني أظن أن فيه الكثير مما يتعلق بالموضوع.
وأعتذر للإطالة فقد أردت إشباع هذا الموضوع لخطورة الشبهة، وأملي أن أكون قد وفقت في الإجابة، ولو بعض التوفيق