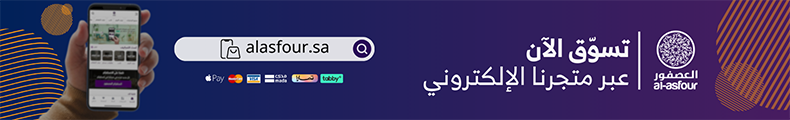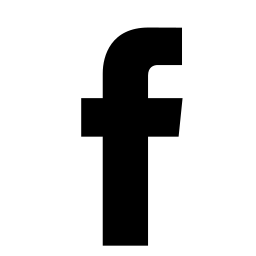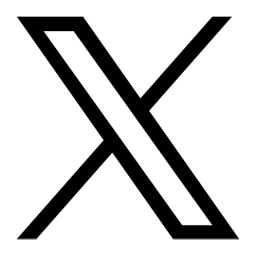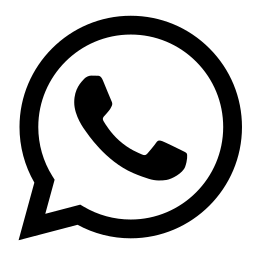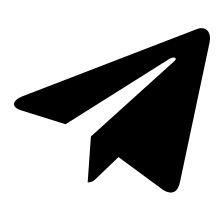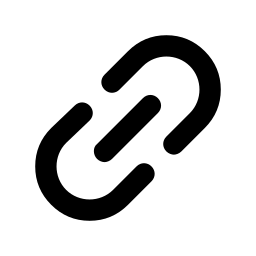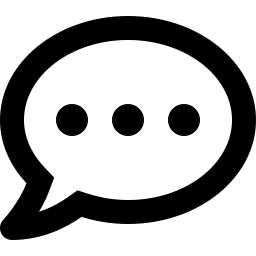الرسالة البغدادية.. كتابة الانتهاك
«أيها القارئ المحتشم لا تقرأ نصاً لكاتب يرسل نفسه على سجيتها»؛ جملة تحذيرية أتخيلها فاتحة لهذه الحكاية الثملة، حكاية الطيش التي كتبها أبو مطهر الأزدي، وينسبها مكتشفها وناشرها لأول مرة المستشرق «آدم ميتز» لفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة «أبو حيان التوحيدي». الاحتشام والخجل والوقار صفات تنبذها «الرسالة البغدادية»، هي محض فظاعة تخدش الحشمة، ومبالغات تهتكية لكاتب هجائي بذيء.
الحكاية التي تعود للقرن الرابع الهجري، وتصور أخلاق البغداديين؛ «حكاية أبي القاسم البغدادي التميمي، وأحواله التي توضح لك أنه كان عرة الزمان وعديل الشيطان ومجمع المحاسن والمقابح، موفوراً من الإخلاص والنفاق، متخلفاً منها بأخلاق أهل العراق»؛ كما يقول الكاتب في نهاية نصه، تدور في يوم واحد فقط، يسرد فيه الراوي حكاية بطله البغدادي عندما قام بزيارة مجلس أعيان في «أصفهان»، حيث منفاه الذي يستثير فيه ذكريات بغداد والغانيات والأدب والشعر، يوم كامل هو الإطار السردي للحكاية التي يصنفها الناقد المغربي عبدالفتاح كليطيو ضمن فن المقامة، ونلمح فيها بداية جنينية لكتابة الانتهاك. يفتتح اليوم بوقار المقدس وينتهي به، وبين هذا وذاك يمعن النص في خرق المقدس وانتهاكه، منهمكاً في محاكاته البارودية. كل شيء فيه، بما في ذلك مأدبة الطعام؛ يمثل مجرد ذريعة للسخرية. الشخصية الانتهاكية جوهرياً شخصية ساخرة، شخصية تهجو العالم لأنها بالضبط شخصية ساخطة معترضة دائماً، وفيما هي تهجو العالم تعريه وتكشف حقيقته، كأن الحقيقة لا تقال إلا على نحو هجائي. الهجائية شكل الحقيقة الأدبي.
يبدو النص منهكاً للقارئ الحديث الذي يتسم بذائقة تنفر من الإطناب والنثر المسجوع المليء بالشعر، إذ خلال المأدبة يثبت أبو القاسم أنه راوية شعر، النص مليء بالشواهد الشعرية من القدماء والمحدثين، من امرئ القيس إلى ابن الحجاج «شاعر الانتهاك الأكبر»؛ لكنه مع ذلك يحظى بقيمته الأدبية والتوثيقية، حيث يقوم بتصوير الواقع الاجتماعي، بكل ما يحتويه من عاهات ورذائل وشر، واقع يتجسد أمامنا كما هو دون تبجيل أو مجاملات، إن التحسين البلاغي في النص يخفف من وطأة تعنيف الواقع بإظهاره على حقيقته.
كل كتابة انتهاكية تتسم ببنية مزدوجة: الشعر والنثر، المدح والهجاء، الشر والخير، القبح والجمال. وهنا، عند أبي مطهر الأزدي: أصفهان وبغداد؛ يقيم كاتبنا تقابلاً بين المدينتين، لكن عينه على وطنه الأم: بغداد، «جنة الموسر وعذاب المعسر، سقى الله مدينة بغداد»، بغداد المرئية هنا في شواهد من الحياة اليومية وحكايات يسودها اللحن اللغوي والسلوكي، حكايات مأخوذة من القاع والمهمش والمستبعد من التاريخ الرسمي «تاريخ السلالات الحاكمة». اللافت أنه يسرد كل شيء فيها ضمن قوائم، كاشفاً عن قدرة إحصائية مذهلة: الطعام، والمراكب النهرية، وأدب الملاحين، ولكن - أيضاً - الغانيات، يقول إنه أحصاهن عام 360 هجرية: «أحصيت أنا وجماعة في الكرخ أربعمئة وستين جارية في الجانبين، ومئة وعشرين حرة، وخمسة وسبعين من الصبيان البدور». الأنوثة الراقصة فرح بغداد وبهجتها.
ولأن الحكاية مقامة، والمقامة - بالتعريف - حديث يدور في مجلس، فكأن هذا المجلس صورة عن العالم، ضيوفه شخصيات نمطية للانتهازي والأديب المتسول وكل ما يستحق الهجاء وبالتالي النقد. يقول الكاتب إنه يكتب محاكاة، أي أدباً تخيلياً، والمحاكاة عند كاتبنا كما عند الجاحظ نقيض ما يقوله أفلاطون، هي أكثر واقعية من العالم، المحاكاة تقول الحقيقة أكثر من الوصف، والأدب أكثر من الفلسفة. وبطل الحكاية، الشيخ الأديب المتهتك أكثر شجاعة على القول من كل أدباء عصره.
البطل كما يصفه الكاتب وجه أحمر يكاد يقطر منه الخمر الصرف، عيّار طفيلي، شيخ خليع منهمك في شتى الضلالات، رقيع وفمه يقطر بالبذاءة. حشد من الصفات يسوقها كاتبنا لهذا البطل الذي يظهر منذ البداية بصفته تجسيداً للسخف. أحمق يختبئ خلف قناع الوقار، هو وحده الذي يعرف أن الحمق قفا الحكمة. غير أن هذا الحمق وتلك السخافة يتحولان إلى النقيض عند كائن تخريبي كأبي القاسم البغدادي، حيث يوحي لنا أن ما بدا سخفاً وحماقة ليس هو كذلك إلا ضمن القيم المهيمنة. وهكذا، فبطل الحكاية شخصية مخادعة تحمل الأقنعة، من عادته - كما يصف كاتب النص - التنكر في مجالس الأعيان. الوقار مظهر سرعان ما يتكشف عن جوهر ساخر وساخط في نفس الوقت، يعطينا الكاتب مثلاً على ذلك أنه زار مجلساً كوقور لينتهي ناثراً سخطه وهجاءه اللاذع على سائر الأدباء والوجوه والأعيان، في حمى هجائية هذيانية لا توفر أحداً.
هذا الشيخ الذي يبصق على أهل الزمان، محتقراً كل شيء؛ هو نرجسي معتد بنفسه كثيراً. لنتذكر ظاهرة القلب التي لاحظها الناقد الروسي «باختين» في الأدب الشعبي والكرنفال: الحياة الكرنفالية حياة مقلوبة دائماً. يصبح المهرج ملكاً متوجاً. إن أناه، تلك «الأنا» الشيطانية، «الأنا» بما هي تجسيد للشر؛ تستحوذ على العالم كسلطان أسطوري، فعندما يثمل الشيخ ثم يهذي ويوزع السخف على الحاضرين متعشقاً بالغانية والغلام الحاضرين في المأدبة؛ يفقد مغني الحفل صبره ويصيح: «من هذا الطاعون؟». الأمر الذي يغضب شيخنا فيجيبه بما يشبه افتخارات قديسة سومرية: «ويلك، تعرفني أولاً؟ أنا أبتلع الرمل وأخرج الصخر، أبلع نوى وأخرج نخل، أنا النار، أنا العيّار أنا الرحى إذا استدار، أنا مشيت أسبوعين بلا رأس، أنا حبست في أجمة فأكلت ما فيها من السباع».
لكنه كمهرج سابق أصبح سلطاناً، لا ينتمي إلى بغداد وحسب، هو مثل المهرج، أو الشعبي، أو المهمش، أو الكائن الانتهاكي باختصار، الكائن الذي ينتهك فيصبح ملكاً، هذا الكائن يوجد في كل مكان، إنه ثقافة، شعر له نكهة الشر، الكلمة سلاحه الأشد فتكاً كأي شاعر، جعلته كلماته يمشي بثلاثة رؤوس ولا يموت حين تضرب عنقه، كلماته تكسر عظام العمالقة، حدثه مرة رجلٌ له رأس بين النجوم ورجلاه تخطان الأرض فبدد وجوده بكلماته: «ويلك، تعرفني؟ يا كلب، أنا أنا، من أنت؟». أنا وحدي إمام أمة داعرة.
وبهذه الصفة يلعب شيخنا الأديب دور الداعية الواعظ والمصلح، ولكن أيضاً بالمقلوب. في نهاية المجلس يطلب القوم نصيحته، فيدلي بوصاياه الانتهاكية: «افتنوا في أكل الطيبات وسماع المطربات المحسنات»، وصية سيكررها الماركيز دو ساد بعد ذلك بقرون: «متع نفسك يا صديقي، واترك للطبيعة عناية أن تتركك على هواها». لكن وصيته الأبرز وصية أيروسية، فشيخ الداعرين انتهاكي ووصاياه انتهاكية، أليس الأيروس انتهاك يمر من جسد إلى جسد؟ أليس الانتهاك فعل حرية؟ فليكن إذن الطموح الأخلاقي إعادة الاعتبار للحرية المهشمة نتيجة إكراهات الثقافة الرسمية والمواضعات الاجتماعية، بحيث يتم اختيارها كممارسة وطريقة عيش، إلى أن تكف عن أن تكون لعنة. وحينها يصبح القول الحر حقاً استثنائياً لكائن جبل على الانتهاك.
ليس الانتهاك مجرد كتابة أدبية موغلة في الشر كما يعبر فيلسوف الأيروسية والانتهاك جورج باتاي؛ وإنما أيضاً موقف من العالم، موقف لا تماثلي واعتراضي، موقف مسكون بالاختلاف والفرادة والحلم والرغبة التي لا تتحقق إلا عند تخوم الموت. تشبه جدلية الانتهاك والامتثال في الأدب جدلية الثورة والواقع المعاش في السياسة. الانتهاك مثل الثورة يتجاوز ذاته دائماً. «الإنسان هو ما ينقصه» كما عبر باتاي. ينهمك الكائن الانتهاكي في حركة نحو ما ليس هو، تماماً مثل الثورة، حركة نحو مطلق جامح ومنفلت دائماً، مطلق عنيد لا يرضخ. في كتابات الماركيز دو ساد، وهي شكل انتهاكي عنيف؛ يرتج المطلق، لأن كاتب الانتهاك يتسم بشجاعة نعثر عليها في الثورة والأيروسية والضحك، ولكن أيضاً في الأدب.
نعرف أن الثقافة تنشق على امتداد تاريخها إلى شعبي ورسمي، لكن هذا الشعبي الماثل في الكرنفال - وهو مهرجان تنكري يتم فيه التحلل من الواحبات والتراتبيات الاجتماعية - والمضحك والهزلي؛ يمتص ببطء في الأدب ككتابة معتمدة وظافرة. لاحظ ذلك باختين حين حاول تقصي جذور شعرية دوستويفسكي، حيث للحقيقة المنطوقة بلسان شخصياته طبيعة حوارية. تتكشف الحقيقة في الساحات والميادين العمومية، وتغامر في الطرق الواسعة وفي أوكار اللصوص والحانات والسجون والحفلات التهتكية. خطاب الحقيقة باختصار خطاب المهمشين المحتكين بأقسى أنواع الشر في العالم. الحقيقة اعتراضية تتكشف بالانتهاك وحده، بالخرق ورفض الرضوخ، الحقيقة ديدن العنيد والمتهتك أيضاً، سيكون مثلاً بطل «مذكرات من داخل القبو» لدوستويفسكي شخصية انتهاكية من الطراز الأول، فهذا الإنسان الذي عذبه أن يكون موضوعاً لتحليلات الآخرين، وأنه معروض لفرجتهم وأحاديثهم؛ يعتبر أن الإنسان كائن حر. ولأنه كذلك فبوسعه «أن يخرق كل أشكال السمات الشرعية والطبيعية التي تفرض عليه».
الأدب اليوم يمتص كل تلك الجينات الانتهاكية، لتبدو الكتابة الأدبية بالتعريف وعلى نحو جوهري كتابة انتهاك. تشيع الباروديا وهي صفة أساسية للأدب الانتهاكي، وينتعش ما أسماه الشاعر والكاتب الأمريكي بوكوفسكي أدباً رخيصاً. بوكوفسكي لوحده ذروة شاهقة لأدب يكسر قواعده وتبجحه الرفيع وحشمته الوقورة، أدب داعر تصبح معه القصيدة أيروسية أبدية لا تخجل من سذاجتها وأرضيتها، حتى إن للتجشؤ جمالياته التي ينبغي أن تساهم في تكوين القصيدة. لا عجب إذن لو اتهم بوكوفسكي «المقبول اجتماعياً» وهو النقيض للانتهاكي بأنه يفتقد الروح والعقل في الآن نفسه.
هكذا يبدو الانتهاكي جسوراً ومغامراً، لأن فعل الكتابة - بتعبير باتاي - فعل المجازفة في الحياة، ولأن الإبداع الحقيقي يتفجر بانفجار رغبة لا يحدها سوى الموت. يظهر الإبداع حيث يظهر اليأس مرتدياً حلة الحكمة الكلبية لفيلسوف أثيني كان يجول ذات مرة في ساحات أثينا بمشعله في وضح النهار عله يجد شريفاً واحداً، وهو ذاته اليأس المحبب لكاتب الانتهاك «جان جينيه» الذي كان يتفاخر بأنه لص على طريقته، فكتب يومياته «يوميات لص». وهو اليأس نفسه من مجتمع رأسمالي حديث يزدري السخف فيما هو يغرق في أوحاله يوماً بعد يوم، يمقت «البطء» متعجلاً نحو اللاشيء، اليأس الأنيق الذي دعا بطلة رواية «الخلود» لكونديرا إلى حمل ما يشبه «مشعل الفيلسوف الكلبي» ليحول بينها وبين معاينة التفاهة والوجوه المتماثلة. وحيث لا يوجد انتهاك لا توجد وجوه.